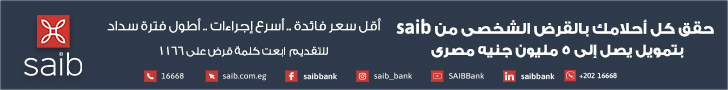أزمة الكهرباء في الكويت.. تحديات و3 سيناريوهات لـ”الإنقاذ الذاتي” (مقال)

لم تَعُد أزمة انقطاع الكهرباء في الكويت مجرّد ظاهرة موسمية ترتبط بصيفٍ حار، بل أصبحت مؤشرًا على مشكلات هيكلية عميقة في منظومة الطاقة والبنية التحتية والإدارة العامة.
فمنذ صيف 2006، بدأت ملامح الأزمة تتجلى، مع تسجيل أول مؤشرات العجز بين الإنتاج والطلب، ومنذ ذلك الحين، أصبحت الانقطاعات المتكررة حدثًا سنويًا يتفاقَم مع ارتفاع درجات الحرارة.
وفي أبريل/نيسان 2025، بدأ انقطاع الكهرباء في الكويت بمناطق سكنية وزراعية وصناعية، مُثيرًا اهتمامًا شعبيًا وإعلاميًا عكسَ قلقًا عامًا بشأن أمن الطاقة في دولة تتمتع بموارد مالية وفيرة.
في هذا الإطار، يُحذِّر الخبير الكويتي المستشار المهندس نجيب عبد الرحمن السعد المنيفي من أنّه “دون إجراء إصلاحات جذرية وعاجلة لأزمة الكهرباء في الكويت، قد تواجه الدولة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتكاليف اقتصادية باهظة، قد يترتب عليها التحول إلى مستوردة للكهرباء بحلول عام 2030″، وهو ما يشكّل تهديدًا مزدوجًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
هل الكويت أمام أعطال فنية عابرة؟
السؤال المحوري هنا لا يتعلق بحدّة الانقطاع أو مدّته، بل بجذوره: هل الكويت أمام أعطال فنّية عابرة؟ أم أمام مشكلات هيكلية مزمنة تتصل بسوء التخطيط، وتأخُّر المشروعات، وضعف كفاءة الحوكمة في إدارة ملف الطاقة؟
تُصرّ الجهات الرسمية على أن تنسب انقطاعات الكهرباء في الكويت المتكررة إلى “الظروف الطبيعية” المرتبطة بارتفاع الأحمال خلال الصيف، وأعمال الصيانة الدورية.
لكن هذا التبرير، على تكراره، لا يُخفي الفجوة الأعمق، وهي غياب رؤية استباقية تُدير العلاقة بين الطلب المتصاعد والطاقة الإنتاجية الفعلية.
فالضغط الموسمي ليس طارئًا على مناخ الخليج، كما أن الحاجة إلى صيانة المحطات ليست مفاجئة.
ما يكشفه الواقع هو استمرار الاعتماد على بنية تحتية شاخت دون تعويض، واستمرار التعامل مع الأزمات بمنطق التسكين لا الإصلاح.
وتشير التقديرات إلى أن صيف 2025 سيشهد عجزًا كهربائيًا يُناهز 1600 ميغاواط؛ نتيجة منطقية لتجميد الاستثمارات في محطات التوليد على مدى أكثر من عقد، وإرهاق المحطات القديمة بأداء يتجاوز قدرتها.
الحادثة التي شهدتها محطة الأحمدي ليست استثناءً، بل عرض لوضع هيكلي مأزوم، لم تنجح المؤشرات الإيجابية المؤقتة -كتحسّن شبكات التوزيع في 2020- في إخفائه.

المطلوب إذن ليس توزيع الأعذار، بل امتلاك ثقافة المراجعة الجذرية، لذا، تحاول الكويت تأمين الوقود عبر تطوير حقول الغاز المحلي، مثل الجوراسية، بهدف إنتاج 950 مليون قدم مكعبة يوميًا من “الغاز الحر” بحلول 2025–2026.
لكن هذه المشروعات تواجه تعقيدات تقنية وإدارية، وقد يستغرق تطويرها 10 إلى 15 عامًا، لذلك، ازداد الاعتماد على الغاز المسال المستورد، لتصبح الكويت أكبر مستورد له في الشرق الأوسط.
ومن أبرز الاتفاقيات عقد طويل الأجل مع قطر لتوريد 3 ملايين طن سنويًا، بدءًا من 2025، ليصل الإجمالي إلى 5 ملايين طن.
وقد وفّر هذا التحول أكثر من 7 مليارات دولار خلال 8 سنوات، لكنه يظل مصدرًا للقلق من الناحيتين الإستراتيجية والاقتصادية، خصوصًا في ظل الاعتماد على مورد واحد.
كما تعاني البنية التحتية للكهرباء من تأخُّر مزمن في مشروعات التوسعة، ما ضاعف الضغط على المحطات القديمة.
فتكلفة بناء محطة جديدة بقدرة 1000 ميغاواط قد تصل إلى 400 مليون دينار، في حين تحتاج البلاد إلى إضافة 13 ألف ميغاواط خلال 5 سنوات.
وقد تبنّت الحكومة برنامج “بنية تحتية متماسكة”، يشمل توسيع محطات شمال الزور والخيران، واستكمال الربط الكهربائي مع السعودية بنهاية 2025.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الكهرباء في الكويت، محمود بوشهري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خطة لإضافة 17 ألفًا و350 ميغاواط، منها 30% من مصادر متجددة، باستثمارات تُقدّر بـ 5 مليارات دينار (16,27 مليار دولار).
وبرغم إعلان الكويت هدف إنتاج 15% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2025، و30% بحلول 2030، فإنها ما تزال تعتمد على النفط والغاز بنسبة 99% في إنتاج الكهرباء.
ويُعزى هذا التباطؤ إلى معوقات مؤسسية وبيروقراطية، مثل تأخُّر تنفيذ مجمع الشقايا منذ 2017، إلى جانب إشكالات تشريعية وآليات تسعير غير مشجعة.
وتعمل وزارة الكهرباء في الكويت -حاليًا- على دراسة إنشاء 4 محطات شمسية بطاقة 2000 ميغاواط، إضافة إلى اتفاقية مع الصين لمشروعات قد تصل إلى 5000 ميغاواط، مع اتجاه لرفع النسبة المستهدفة وإشراك المواطنين في منظومة الإنتاج.
الكويت من الدول الأعلى استهلاكًا
في سياق الاستهلاك، تُعدّ الكويت من الدول الأعلى عالميًا في معدل استهلاك الفرد للطاقة، إذ يشكّل التكييف نحو 70% من الطلب السكني.
وفي هذا الإطار، تكتسب المقارنة الإقليمية في معدلات استهلاك الطاقة أهمية تحليلية لفهم أبعاد الوضع الداخلي.
فبحسب بيانات وكالة Enerdata ووكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بلغ متوسط استهلاك الفرد في الكويت عام 2023 نحو 365,9 غيغاجول، وهو رقم مرتفع، وإن ظل دون نظيره في بعض دول الخليج.
ففي قطر، بلغ استهلاك الفرد 817 غيغاجول، بينما بلغ في الإمارات نحو 430 غيغاجول، وفي السعودية قرابة 314,1 غيغاجول.
وتكشف هذه الأرقام نمطًا مشتركًا يتمثل في ارتفاع استهلاك الطاقة بفعل المناخ والاعتماد على التكييف والصناعات كثيفة الاستهلاك، لكن التفاوت بينها يعكس اختلافًا في مزيج الطاقة وسياسات الكفاءة.
لذلك، فإن هذه الأرقام لا تُستَعمَل فقط لأغراض توصيفية، بل تُسهم في فهم أعمق للعلاقة بين الموارد والحوكمة، وما تعكسه من مدى فعالية السياسات الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثّر ضعف الحوكمة وتراكُم البيروقراطية في قطاع الكهرباء في الكويت بشكل كبير، فالمركزية وطول الإجراءات تعوق تنفيذ المشروعات، وتؤدي إلى إضاعة الفرص.
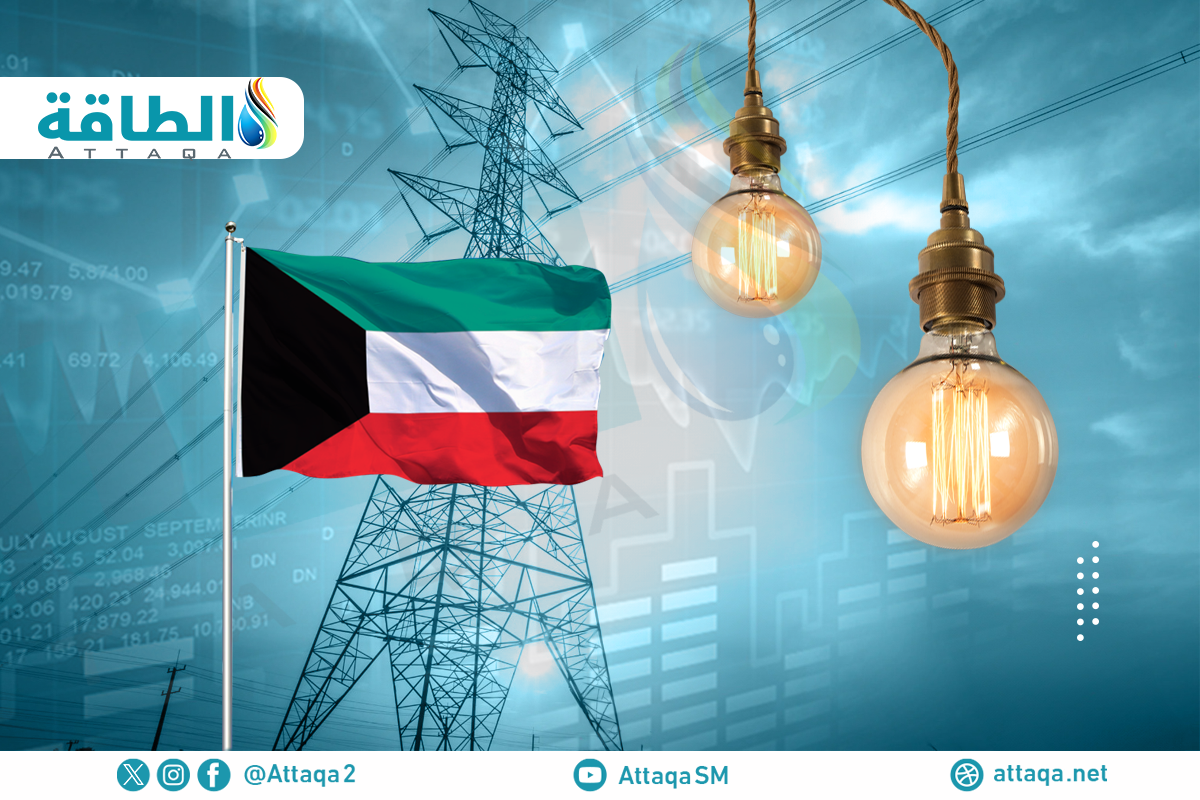
قضايا الشفافية والمساءلة
رغم وجود هيئات رقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة، فإن قضايا الشفافية والمساءلة ما تزال تشكّل تحديًا حقيقيًا، وهذا المناخ يزيد من تعقيد تنفيذ المشروعات، ويرفع تكاليفها.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو رفض الكويت مقترحات قدّمتها 8 شركات دولية ضمن نظام المورّد المستقل لتوفير الطاقة والمياه بأسعار تنافسية، ودون أيّ تكلفة على الدولة.
ومن أبرز هذه العروض كان مقترح الشركة النرويجية “سكاتك” لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1300 ميغاواط، دون أيّ تكلفة على الكويت، وهو العرض الذي جرى تجاهله لمدة عام كامل.
ومع تردُّد الكويت، اختارت الشركة تحويل استثماراتها إلى مصر التي استغلت الفرصة لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 5000 ميغاواط، وهو ما يعكس إهمالًا خطيرًا للأمن الطاقي في الكويت.
هذا إلى جانب المشكلات الأخرى التي يعاني منها قطاع الكهرباء في الكويت، نتيجة للجمود المؤسسي والمقاومة للإصلاحات السوقية التي حققت نجاحات كبيرة في دول الجوار.
فقد أُعِدَّ قانون لإنشاء الهيئة العامة للكهرباء منذ 12 عامًا، لكنه ما يزال حبيس الأدراج، رغم موافقة الهيئات التنظيمية المعنية.
كما أن خطط خصخصة الكهرباء في الكويت تأخرت، بينما لم تُطبَّق القوانين الخاصة بمكافحة الاستعمال غير المصرَّح به للكهرباء، مثل تعدين العملات الرقمية، إلّا مؤخرًا، في ظل الأزمة الحالية.
وفي مقارنة واضحة مع دول الخليج الأخرى، نجد أن معظمها قد وضع إستراتيجيات طويلة الأمد لضمان أمن الطاقة لعقود قادمة، واستقطبَ الاستثمارات الأجنبية لتفادي أزمات الكهرباء.
بينما استمرت الكويت في تهميش الحلول المقترحة بسبب البيروقراطية، ما أفقدها القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية مؤثّرة في هذا المجال.
حلول مؤقتة لمواجهة الأزمة
تلجأ الكويت حاليًا إلى حلول مؤقتة لمواجهة الأزمة، مثل استيراد الكهرباء عبر الربط الخليجي، واستيراد الغاز المسال، وأعمال صيانة طارئة، وحملات توعية لترشيد الاستهلاك.
وعلى الرغم من أهميتها قصيرة الأجل، فإن هذه الإجراءات لا تُعالج جذور المشكلة.
وفي هذا السياق، خلصت دراسة أعدَّها محيي عامر وفهد التركي، نُشرت في صحيفة الجريدة الكويتية عام 2024، إلى حزمة من المقترحات الإصلاحية لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد.
ودعت الدراسة إلى اعتماد نموذج “المزوّد المستقل للكهرباء IPP” الذي أثبت فاعليته في دول عديدة، ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30%، مع إشراك المواطنين في إنتاج الطاقة، سواء من خلال أسطح المنازل أو مشروعات صغيرة.

كما أوصت بتحويل وزارة الكهرباء إلى مؤسسة مستقلة ذات طابع تشغيلي، تُدار بكفاءة بعيدًا عن البيروقراطية، إلى جانب اعتماد شرائح استهلاكية عادلة تعكس حجم الاستعمال، ومراجعة السياسات الإسكانية بما يقلل الهدر في الطاقة، وتعزيز التشجير لكونه أداة لتخفيف الحرارة وتقليل الضغط على استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.
وتُظهر تجارب الإمارات وسلطنة عمان إمكان تحقيق تحوّل جذري عبر التخطيط المبكر، والاستثمار في الطاقة النظيفة، وبناء مدن مستدامة.
ويمكن استشراف مسارات مُحتَملة لمستقبل أزمة الكهرباء في الكويت، تعتمد على عدّة عوامل حاسمة تحدّد وتيرة ومدى نجاح جهود “الإنقاذ الذاتي”.
وتشمل هذه العوامل أساسًا: توافر الإرادة السياسية وقدرة المؤسسات على تنفيذ الإصلاحات، وسرعة إقرار وتفعيل التشريعات الداعمة للقطاع الخاص والطاقة المتجددة (مثل قانون الهيئة العامة للكهرباء)، ووتيرة تنفيذ مشروعات التوسع في التوليد وتطوير مصادر الوقود، وفعالية سياسات ترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب.
وفي ضوء هذه العوامل وديناميكياتها، يمكن تصوُّر 3 سيناريوهات رئيسة لمسار تطور الأزمة في عام 2025 والأعوام القادمة:
سيناريو استمرار التدهور (القصور الهيكلي):
في هذا السيناريو، لا يُحْرَز تقدُّم جوهري في معالجة الأسباب الجذرية لأزمة الكهرباء في الكويت.
إذ تستمر المعوقات البيروقراطية والمؤسسية في تعطيل المشروعات الكبرى (محطات التوليد الجديدة، تطوير الغاز المحلي، مشروعات الطاقة المتجددة).
ولا يحدث إقرار أو تفعيل القوانين والتشريعات الضرورية للإصلاح (مثل قانون الهيئة العامة للكهرباء أو آليات تشجيع القطاع الخاص ونموذج IPP بفاعلية).
ويظل الاعتماد على الحلول المؤقتة (استيراد، صيانة طارئة، ترشيد محدود) هو النهج السائد، ويترتب عليه تفاقُم أزمة الكهرباء في الكويت، مع تكرار الانقطاعات وتوسُّع نطاقها الجغرافي والزمني، خاصة خلال أوقات الذروة.
ويزداد العجز بين العرض والطلب. وتتزايد التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك التأثير السلبي في قطاعات حيوية مثل النفط والمشروعات السكنية الجديدة.
وتزداد الضغوط الاجتماعية والشعبية، وقد تتجه الكويت نحو أن تصبح مستوردًا منتظمًا للكهرباء بحلول نهاية العقد الحالي؛ مما يهدد أمنها الطاقي والاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
سيناريو الإصلاح التدريجي (التحسن البطيء):
يشهد هذا السيناريو بعض التحرك الإيجابي في أزمة الكهرباء في الكويت، ولكن بوتيرة بطيئة وغير حاسمة.
إذ تُقَرّ بعض القوانين أو التعديلات التشريعية، ولكن تطبيقها يواجه تحديات بيروقراطية وتنفيذية، وتبدأ بعض المشروعات الجديدة (سواء توليد تقليدي أو متجدد)، ولكنها تتأخر عن جداولها الزمنية المقررة.
وقد تحدث مشاركة محدودة للقطاع الخاص، أو الاعتماد بشكل أكبر على الدعم والاتفاقيات الخارجية لتغطية العجز.
كما قد تُبذَل جهود أكبر لترشيد الاستهلاك أو مراجعة محدودة لشرائح التسعير، ويترتب عليه تحسُّن الأزمة بشكل جزئي وبطيء، إذ قد تُخفَّف حدّة الانقطاعات في بعض السنوات أو المناطق، ولكن التحدي الهيكلي يظل قائمًا.
وتظل البلاد عرضة للضغوط خلال أوقات الذروة الشديدة أو عند حدوث أعطال مفاجئة، ويستمر الاعتماد على الحلول الخارجية.
ولا يتحقق التحول المنشود نحو مزيج طاقة أكثر استدامة أو نظام أكثر كفاءة ومرونة بالسرعة المطلوبة لمواكبة النمو المستقبلي في الطلب.

سيناريو الإصلاح الجذري (الإنقاذ الذاتي):
يمثّل هذا السيناريو تحقيقًا للإرادة السياسية والقدرة المؤسسية على معالجة أزمة الكهرباء في الكويت من جذورها.
إذ يجري إقرار وتفعيل حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والإدارية بسرعة وفاعلية (قانون الهيئة، آليات IPP، تيسير الإجراءات).
كما يجري إطلاق وتنفيذ مشروعات كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية (خاصة المتجددة) بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص المحلي والدولي.
ويحدث تقدّم ملموس في تطوير مصادر الغاز المحلية وإدارة الطلب بفاعلية أكبر (تسعير، كفاءة)، وتعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع الطاقة.
ويترتب عليه تجاوز مرحلة العجز والانقطاعات المتكررة في غضون سنوات قليلة، وتتحسن كفاءة وموثوقية الشبكة بشكل ملموس، ثم بناء منظومة طاقة أكثر استدامة وتنافسية لتستعيد الكويت زمام المبادرة في تأمين أمنها الطاقي، والاعتماد بشكل أكبر على قدراتها الداخلية ومواردها (بما في ذلك الشمس والرياح)؛ مما يعزز موقعها الاقتصادي والإستراتيجي على المدى الطويل.
أزمة الكهرباء في الكويت
إجمالًا، لا تعدّ أزمة الكهرباء في الكويت مجرد تحدٍّ فني أو مالي، بل هي اختبار لقدرة الدولة المؤسسية.
فبرغم مواردها المالية، تظل الإصلاحات الإدارية والهيكلية ضرورية لتوظيف هذه الموارد بفعالية.
ويبقى السؤال المركزي: هل تعتمد الكويت على “إنقاذ خارجي” مؤقت، أم تتبنى “إنقاذًا ذاتيًا” بإصلاحات شاملة؟
فالأزمة تتجاوز البُعد التقني لتشكّل تهديدًا اقتصاديًا جسيمًا، فالعجز يعوق المشروعات ويُهدد قطاع النفط الحيوي، عمود الاقتصاد الكويتي.
والمشكلة داخلية بالأساس، وحلّها يكمن في إصلاحات داخلية شاملة، لكن تحقيق الإصلاح الجذري يواجه عقبات هيكلية عميقة: البيروقراطية، وتأخُّر التشريعات (كقانون هيئة الكهرباء المنتظر)، ومقاومة مشاركة القطاع الخاص.
هذا الواقع قد يجعل سيناريو “الإصلاح التدريجي” أو “استمرار التدهور” أكثر احتمالًا دون إرادة سياسية قوية.
وهنا تبرز أبرز الإصلاحات الضرورية: تفعيل قانون هيئة الكهرباء (كإطار لإصلاحات السوق)، وتسريع مشروعات الطاقة المتجددة (لمواجهة الذروة)، وتجاوز مقاومة إشراك القطاع الخاص (كنماذج IPP الناجحة إقليميًا).
هذه الخطوات أساسية لتحولات إستراتيجية تحلّ الأزمة، وتعزز قدرة الكويت على مواجهة المستقبل.
رامز صلاح.. باحث مهتم بالقضايا الدولية
موضوعات متعلقة..
- مفاجأة حول ارتفاع أحمال الكهرباء في الكويت.. وقرار عاجل من “الداخلية”
- الطلب على الكهرباء في الكويت قد يرتفع 3%.. هل يُفاقم الأزمة الحالية؟
- قطع الكهرباء في الكويت لمدة أسبوع.. تفاصيل المناطق وساعات فصل التيار
اقرأ أيضًا..
- حقل نفط أفريقي يحظى بقرار مهم في 2026.. احتياطياته 3 مليارات برميل
- أنبوب الغاز العراقي يعبر نهر دجلة.. تطورات جديدة (صور)
- واردات سوريا من النفط منذ سقوط نظام الأسد.. قائمة بـ4 دول (رسوم بيانية)